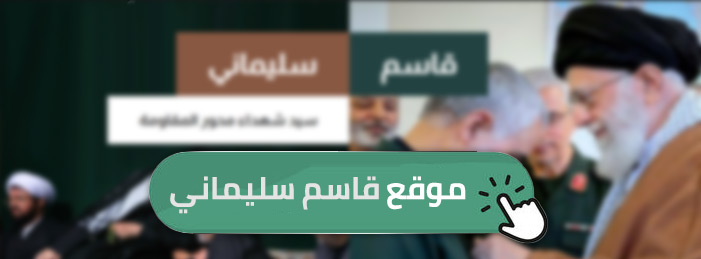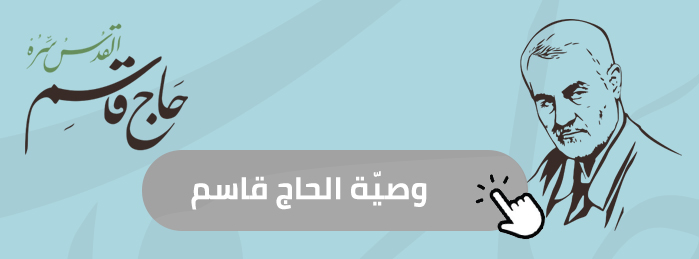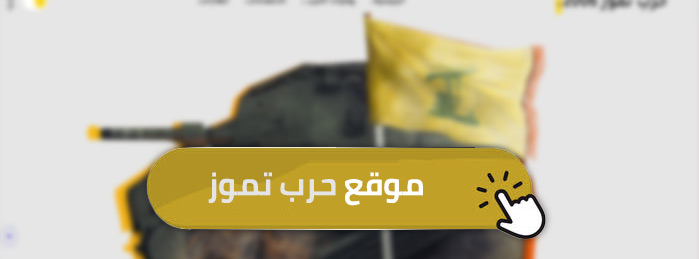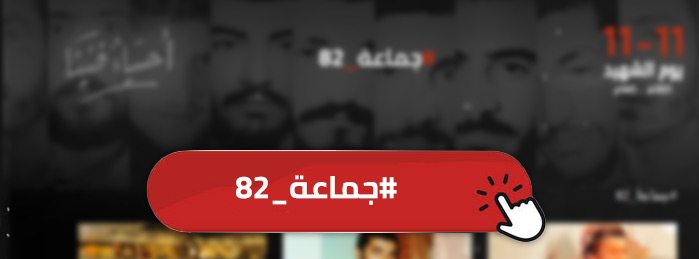آراء وتحليلات
الوباء الأميركي والعقيدة الوطنية
أحمد فؤاد
في غمرة الانفجار الذي هز الشرق الأوسط، وفي القلب منه مصر، في 1967، والمشهور في العالم العربي بالنكسة، وجدت مصر مخلّصيها، قامات عظيمة مثل جمال عبدالناصر وعبد المنعم رياض وغيرهما، كفل إيمانهما بالقضية المركزية، وقدراتهما وعدالة مقاصدهما، حصار الآثار العاجلة للكارثة العربية المروّعة، وبدأت مصر على مهل لملمة شتاتها، ثم عادت رايتها تتألق بعد شهور فيما سيعرف بحرب الاستنزاف.
"الحظ" - إن أمكننا الاصطلاح - الذي لم يكن حليفًا للبلد على طول الخط، أفقدها أحد أعظم أبنائها على جبهة الاستنزاف، الفريق عبد المنعم رياض. ورغم التزام عسكري صارم، أحاط به الشهيد حياته، ثم ثقل المهام والأعباء، فقد تسربت قناعات على شكل جمل نُسبت إليه، كان لا يفتأ يرددها أمام كل مسؤول التقى به أو جمعتهما جلسة حديث، وتدور كلها بالطبع حول القتال والشرف الفردي المرتبط جدًا، وعميقًا، بالمعركة مع الكيان الصهيوني، الجبهة الشرقية لمصر، جبهة الخطر منذ فجر التاريخ. وعلى رأس ما كان يلقيه على مسامع زواره جملة فارقة الدلالة، نقلها الصحفي العربي الكبير الراحل محمد حسنين هيكل: "إذا عادت سيناء بغير قتال، يدفع الجميع ثمنه، ومعركة تستمر طويلًا، يشعر الناس بثقلها وأعبائها، فإن البلد ستنهار أخلاقيًا، وتسقط القيم فيها، ضرورة المعركة العسكرية لتحرير الأرض العربية تمس شرف كل مواطن في هذا البلد".
باختصار شديد، فقدت مصر برحيل رياض العسكري النابه صاحب الفكر الإستراتيجي، قارئ التاريخ الذكي، الذي رأى مبكرًا الخطوط الحمراء لدور الجيش في الداخل، وجسد بشهادته ودمه قدسية رسالة المقاتل العربي، ونبل التضحيات، مهما بلغت جراحها، ومعانيها الكبرى.
الجيش بالإيمان والعقيدة، وبهتاف الله أكبر، الحاضر في خلفية مشهد العبور، مكن الجنود من إلغاء تأثير التفوق الجوي الصهيوني، والعبور تحت حماية شبكة دفاع جوي متقدمة، وبتغطية من صواريخ قادرة على صناعة توازن الردع مع الصهيوني، وهي كلها من بنات أفكار رياض، واضع خطة "جرانيت 1" و"جرانيت 2"، التي جعلت عبور القناة وتدمير خط بارليف ممكنًا، بقدر متحمل من التضحيات.
ومع وجود السادات، على رأس القيادة المصرية، خلال حرب أكتوبر/تشرين أول التحريرية، فقد استشهاد رياض كل صلة له بالواقع، وجرى -في حماس وتصميم بالغين- طمس ذكراه، ونسيان دوره، حتى بدا أن الرجل كان رئيس أركان لجيش دولة في آخر العالم، وليس أرفع رتبة عسكرية مصرية سقطت في ساحات الشرف والقتال.
بعد عقود من استشهاد رياض، ورغم الإحياء السنوي التقليدي لذكرى شهادته، في كل وحدة عسكرية، صباح التاسع من مارس، إلا أن المقاصد والغايات اختلطت، وصارت "احتفالية" تماثل ما يجري في أي ذكرى أخرى غيرها، يحفظ الناس تواريخها وتتلاشى من ذاكرتهم شيئًا فشيئًا عظمة اللحظة وتجلياتها.
الإيمان ذاته الذي غلف حياة عبد المنعم رياض، وخلد حكاية استشهاده وسط جنوده، يغيب الآن عن المشهد المصري كله، ليس الجيش كمؤسسة فحسب، لكنه فقد اتصاله مع فكرة الدولة ككل، ثم انحطت فكرة الدولة إلى ما يشبه "الشركة"، الباحثة عن ربح في سوق، وليس شكلًا من أشكال الحكم، ينوب عن عموم الناس في تحقيق مصالحهم، أو حتى بعض مصالحهم.
ويبقى تحذير واحد، من خطورة المعونة العسكرية والاقتصادية للجيش المصري، والتي تدفقت كسيل جارف، قبل وخلال وبعد محادثات الاستسلام المصرية الصهيونية، المتوجة بإكليل العار المسمى كامب دافيد، وأُريد لها أن تفتح العيون في المؤسسة العسكرية المصرية على ميزات اجتماعية تخاصم الجندية، وتغازل البعض بامتلاك رفاهية عصية على معظم الناس، وبالتالي كانت تستهدف تجذير وتعميق خصام "مصنوع وممول" أميركيًا بين الجيش وباقي أفراد الشعب.
يقول الدكتور النابه، والاقتصادي الفذ، الراحل سمير أمين، في كتابه ثورة مصر، الصادر في الأيام العاصفة من عام 2011: إن الخوف من "تطبّع قيادة الجيش الحالية بالهوى الأميركي، مع دفعات الضباط ممن تلقوا التعليم العسكري الأساسي في واشنطن –عن طريق البعثات والدورات التدريبية التي تمتد لشهور طويلة- كما أن الجيش اشترك في المناورات طوال الأعوام الأخيرة، مع القوات الأميركية المتواجدة بالمنطقة، وهو يقدم لها الخدمات المعاونة، وانصراف الجيش عن العمليات القتالية إلى العمليات المدنية وهطول الأموال الأميركية عليه، في شكل معونات عسكرية تقدر بـ 1.5 مليار دولار سنويًا، قد يحوّله، مع ما سبق ذكره، عن العقيدة الوطنية القتالية إلى شركة الجيش، التي يحقق أعضاء مجلس إدارتها أرباحًا طائلة، ويخصصون لأنفسهم رواتب باهظة من احتلال مقاعد الإدارة فيها، وهم يعرفون يقينًا أن المعونة العسكرية الأميركية هي رأسمال شركتهم، وهو ما يكشف أسباب اضمحلال العقيدة في الجيش، واستشراء الفساد بين صفوفه، والامتيازات والكوادر الخاصة للرتب العسكرية العليا، والبدلات المرتفعة التي حصلوا عليها في ظل نظام مبارك، تجعلهم مرشحين دائمًا للعب دور التكتل الرجعي الذي يستهدف ضرب المد الثوري، والحفاظ على جوهر النظام كما هو".
يؤكد أمين أن هذا بالضبط كان دور الجيش، كما رسمته واشنطن أثناء وفي أعقاب انتفاضة الشعب في 25 يناير 2011، معتبرًا أن نموذج باكستان هو ما كان يسعى أوباما لفرضه في مصر، عن جيش يحكم من خلف ستار، بأوامر وتعليمات البنتاجون.
ولتوضيح عمق وخطورة رهان واشنطن على الجيش، يضيف أمين، أن "أي تحرك ثوري في مصر هو تحرك ضد الغرب والسيطرة الأجنبية، وضد الكيان الصهيوني، سواء كان الدافع وطنيًا أو قوميًا، فالملايين من الشباب ممن خرجوا ضد مبارك يحملون كراهية وعداء كاملين لمشروع الغرب في المنطقة، أي قاعدتهم العسكرية المتقدمة، ممثلة في الكيان الصهيوني، وأي تحرك نحو ديمقراطية فهو تحرك بالضرورة إلى تقدمية وبالصيرورة ضد مصالح الغرب"، ويحلل بحسم خيارات الانتفاضة الواسعة أن "مطلبهم الأسمى المتمثل في حريات سياسية هو مطلب صحيح تمامًا، لأنه مطلب يتجاوز الوسيلة إلى هدف إعلان العداء للاستعمار، والعمل بمقتضاه".
أي أننا أمام طرح، يقول إن واشنطن، حين ستجد مصالحها أمام ثورة شعبية -أو انتفاضة- في أي بلد عربي، فإنها حاولت وتحاول وستحاول، إغراء الجيوش لمخاصمة تطلعات الشعوب، التي تصطدم لا محالة بسيطرتها، وتهدف للخروج من رقبة التبعية المقيتة لواشنطن، وهي جاهزة بالجزرة والعصا، فالمعونات قد تتوقف أو تستمر، واعتماد الجيوش العربية على السلاح الأميركي لا يترك هامشًا كبيرًا للمناورة، مع احتياجه الدائم لقطع الغيار والذخائر، وهي واشنطن- قادرة باستمرار المنع على تحويل السلاح لخردة في يد مستخدميه.
باختصار..
لكن وطنا بحجم مصر وجيشا بتراثه وتقاليده وعلاقته البنيوية مع الشعب، هو قادر على مقاومة هذه المؤامرة وتفكيك مركباتها الخبيثة، وهو أمل لكل مصري وعربي، يرى من استعادة مصر لوجهها ودورها أمرا حتميا، وتعجيلا لا خلاف عليه بالخلاص من الوجود الاستعماري بمنطقتنا الموبوءة.
إقرأ المزيد في: آراء وتحليلات
17/04/2024
عملية عرب العرامشة: الصفعة المؤلمة
17/04/2024
"الوعد الصادق" ونهاية الملاذ الآمن
التغطية الإخبارية
المقاومة الإسلامية تستهدف فريقاً فنياً للعدو أثناء صيانته للتجهيزات التجسسية في ثكنة راميم
سرايا القدس: في تاسعة البهاء جددنا قصفنا لمدينة "عسقلان" المحتلة برشقة صاروخية
إعلام العدو: إطلاق صاروخ من شمال قطاع غزة تجاه عسقلان
لبنان: مدفعية العدو تستهدف الأطراف الغربية لبلدة حولا
فلسطين: صفارات الإنذار تدوي في عسقلان لأول مرة منذ شهرين
مقالات مرتبطة

النخالة: نتائج زيارة بايدن معلومة لشعبنا.. وعلينا تكثيف المقاومة لنأخذ حقوقنا

كيف دفع الملك الأردني ثمن مواقفه الداعمة للقدس؟

حزب الله أحيا عيد المقاومة في راشكيدا البترونية وكلمات نوهت بانتصار غزة

قلق إسرائیلي من عودة بایدن